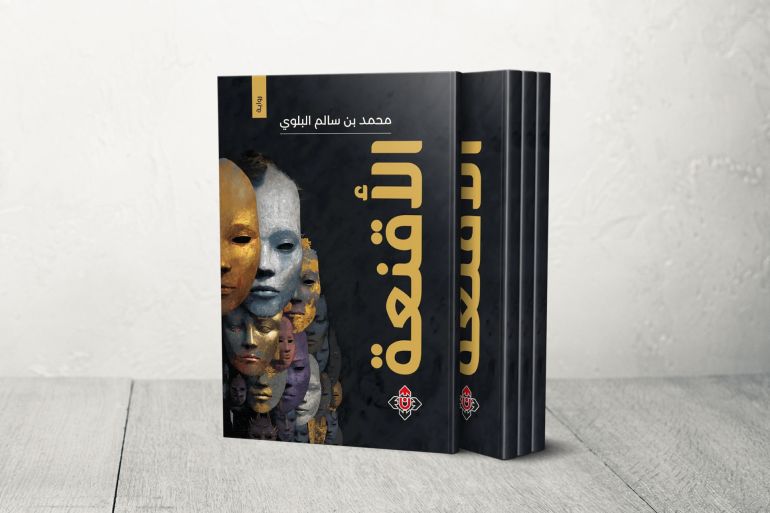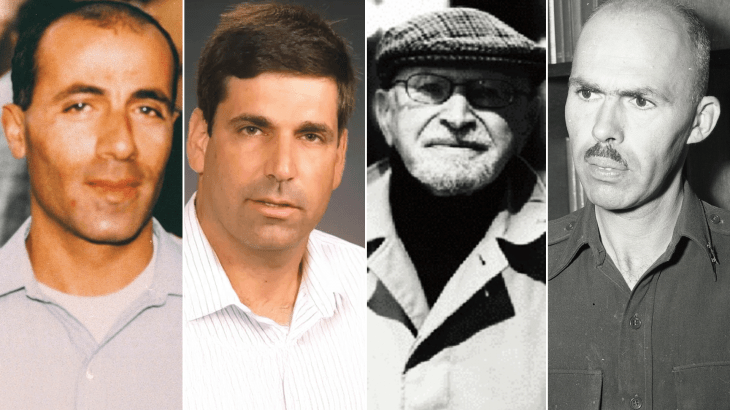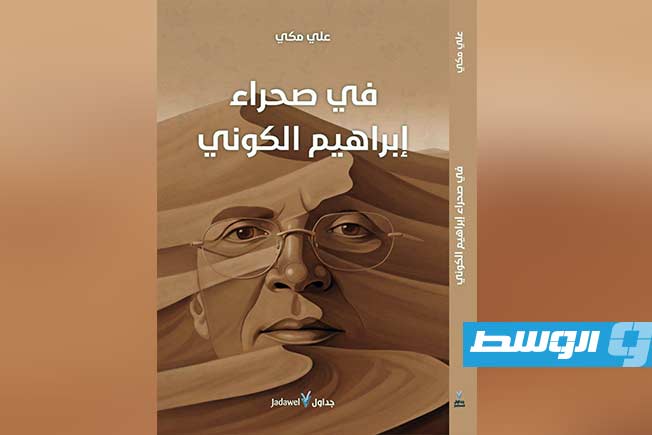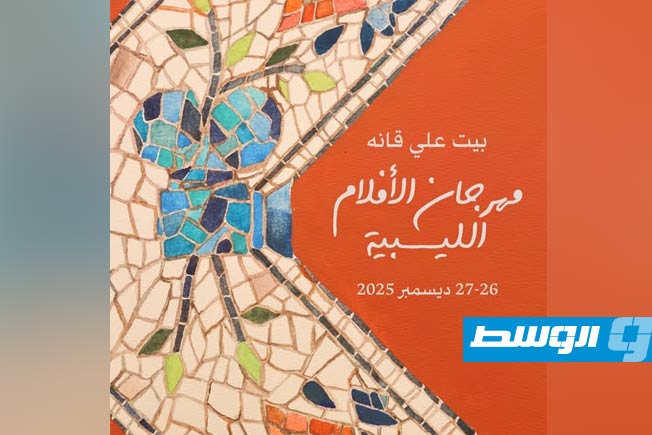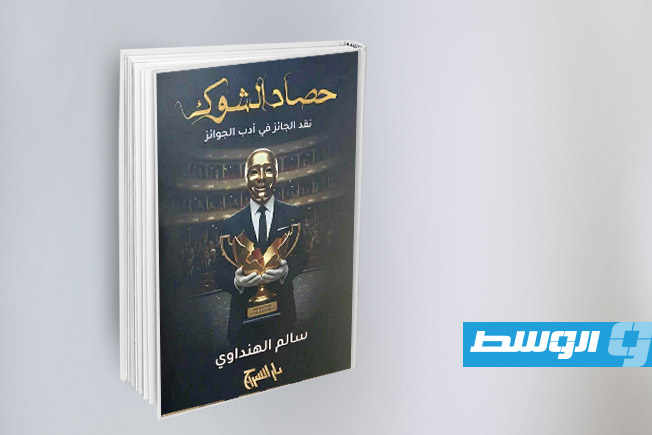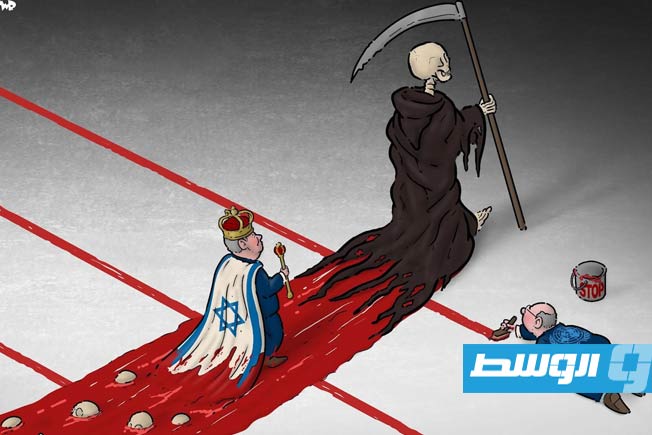أمستردام- بعد ثلث ساعة من مشاهد بصرية متقطعة للكهوف والأنفاق والمياه التي لم تكشف عن معناها المباشر، كنت على وشك مغادرة قاعة العرض لمشاهدة فيلم آخر في قاعة مجاورة بالمسرح الدولي المستضيف للمهرجان في قلب العاصمة الهولندية.
لكن بالضبط عندما بدأ الراوي التحول إلى الحديث عن كيف تحولت تلك الملاجئ تحت الأرض إلى مسارح لمآسي بشرية مروعة، اعتدلت في مقعدي وقررت المواصلة، مأخوذاً بقوة حكاية الراوي. فقد روى كيف مات العديد من الناس جماعياً داخل كهوف أوكيناوا، التي شهدت بعض أشرس فصول الحرب العالمية الثانية في الأشهر الأخيرة من الحرب، عندما لجأ آلاف المدنيين اليابانيين إلى الكهوف الطبيعية في أوكيناوا (المعروفة محلياً في اليابان باسم ‘غاما’) هرباً من الجنود الأمريكيين.
شهود على المأساة
من خلال إحياء روايات الناجين والمآسي المنسية، يساهم الفيلم في مناقشة موضوع الحرب في الوعي الياباني. بالكاد يبدأ في استكشاف البلدة الغارقة قبل أن يوثق قصص حالات الانتحار الجماعي القسري التي وقعت في تلك الكهوف خلال المراحل النهائية من حرب المحيط الهادئ عام 1945.
يمثل الفيلم محاولة جادة لإنقاذ التجارب الإنسانية الغارقة عبر الفن السينمائي، مؤكداً أن الكاميرا هي ذاكرة بديلة تحفظ الماضي من الضياع.
على سبيل المثال، شهد كهف واحد – يُعرف باسم “تشيبيتشيري غاما” – مقتل أكثر من 80 مدنياً دفعة واحدة في حادثة انتحار جماعي مأساوية. عندما بحثت في هذه الظاهرة، فهمت أن هذا المصير لم يكن حتمياً؛ فالكثير من حالات الانتحار الجماعي هذه نتجت عن ضغط نفسي مارسته السلطات والمجتمع على المدنيين لإقناعهم بأن الاستسلام للعدو أسوأ من الموت.
سرد الفيلم لا يتبع حبكة تقليدية بقدر ما يجري مع تيار حر للأحداث والصور. فهو يوثق موضوع الحرب بالغوص حرفياً في عالم الكهوف تحت سطح اليابان، بما في ذلك قصص حالات الانتحار الجماعي القسري التي وقعت في تلك الكهوف خلال المراحل النهائية من حرب المحيط الهادئ عام 1945.
يظهر عنوان الفيلم كدعوة هادئة للنزول تحت السطح، إلى عالم تحت الأرض تسكنه بقايا آثار البشرية، أشبه برحلة وجودية إلى طبقات الوعي الجمعي الياباني.
تبدأ قصة “تحت الأرض” بشرارة بصرية عابرة عندما تواجه امرأة صوراً قديمة أو مقاطع فيلم في قاعة عرض. تقودها تلك المشاهد للبحث عن حقيقتها.
بطل الفيلم – الذي لا يتحدث طوال الفيلم – تكتشف أن تلك المقاطع تنتمي إلى بلدة اختفت حرفياً تحت مياه بحيرة تشكلت خلف سد شاهق. مدفوعةً بالفضول، وربما الحنين إلى ماضٍ لم تعرفه أبداً، تسافر إلى ذلك المكان الغارق.
وهكذا تبدأ رحلة البحث، رحلة تقودها عبر الزمن وآثار الماضي. الشخصية الرئيسية هنا ليس لها اسم محدد وتظهر كظل أو شبح بشري، تتجول بحرية عبر المشاهد، أحياناً عبر يد تمتد من جانب الإطار، راضيةً ببصمتها وحضورها الحالم. تصبح هذه المرأة دليلنا عبر المتاهات تحت الأرض.
يتجاوز الفيلم بسرعة المهمة الحرفية لإيجاد البلدة الغارقة لينخرط في استكشاف أوسع لأماكن خفية ومكبوتة في الذاكرة الجمعية، متنقلاً بين مواقع تحت أرضية متعددة.
جماليات الظلام
تنتقل الكاميرا من أنفاق خرسانية مهجورة تحت مدينة حديثة، إلى كهوف طبيعية في أوكيناوا شهدت مآسي حرب دموية، وأخيراً إلى أنقاض القرية الغارقة نفسها في قاع البحيرة. لا يكشف الفيلم مباشرة عن أسماء أو تفاصيل هذه الأماكن؛ فالانتقالات ضبابية عن قصد، كما لو كانت جزءاً من حلم.
كما تتداخل الفترات الزمنية، حيث تُعرض لقطات أرشيفية ومقاطع قديمة فوق مشاهد الحاضر دون تسلسل سببي واضح. ومع ذلك فهي مترابطة بمجموعة من الرموز أو الأحاسيس رغم غياب الحوار والشرح المباشر. من هذه الزاوية، يبدو الفيلم “ما بعد حداثي” بامتياز، من حيث تقويضه للبنية السردية والأسلوب الوثائقي المألوف لدى المشاهد.
رغم هذه الجماليات، بدا الفيلم مُربكاً لي بسبب أسلوبه التجريبي الجريء. فالسرد المجزأ والانتقالات المفاجئة بين المشاهد تربك من يفضلون خطاً قصصياً واضحاً، مما يجعل مشاهدة الفيلم أشبه برحلة تتطلب صبراً – وهو شيء كدت أن أفقده عدة مرات أثناء المشاهدة.
قبل أن ينغمس المشاهد في هذه الرحلة التأملية